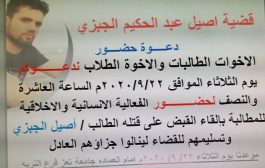كتاب المواطن – روجيه جارودي
ولنأخذ ميدانًا ذا أهمية أكبر أيضًا، ميدان تغذية البشر، فنسبة السكان الزراعيين الضروريين لإطعام المدن لم تتغير إلا على نحو لا يذكر طوال ألوف الأعوام، وفي مطلع القرن العشرين كانت تزيد على 50% حتى في البلدان المتطورة, ولم تتدن إلى 15% في فرنسا، وإلى 7% في الولايات المتحدة، إلا في النصف الثاني من القرن العشرين.
وفي حين أن الانتاج الاجمالي للسلع والخدمات لم يتبدل طوال ألوف السنين إلا بنسبة 3 أو 4% في القرن الواحد أو حتى بنسبة 20 إلى 30% بعيد الثورة الصناعية الأولى، فإنه يتضاعف الآن في الأقطار المتطورة مرة كل خمسة عشر عامًا، بحيث أن المجتمع بات ينتج بزيادة اثنين وثلاثين ضعفًا عند بلوغ المرء من الشيخوخة قياسًا إلى حجم الانتاج في عام ميلاده.
وتطور المعارف اشد بهرًا أيضًا، فثمة تقرير مشهور لليونسكو يفيد بأن 90% من العلماء الذين عاشوا منذ بداية الحضارة هم احياء اليوم، وكتب واحد من خيرة الاختصاصيين العالميين في البرامج المدرسية المبثوثة إذاعيًا و تلفزيونيًا يقول: “قياسًا إلى الوتيرة التي تطور بها المعرفة، فإن جملة معارف البشرية ستكون أكبر بأربع مرات حين يتخرج من الجامعة الطفل الذي يولد اليوم، وحين يناهز الخمسين من العمر، سيكون 97% مما سيعرفه قد تم اكتشافه منذ ولادته”.
والانقلاب الذي رافق اختراع التلفزيون لا يضارعه إلا الانقلاب الذي ترتب على اكتشاف الكتابة، فالتلفزيون لم يدخل تبدلًا كميًا على نشر الثقافة كما فعلت المطبعة فحسب، بل أدخل تبدلًا نوعيًا على مضمون الثقافة بالذات، إن العصر التاريخي الذي كانت فيه الكتابة الوسيط الوحيد بين الإنسان والعالم قد طويت صفحته وبات في مستطاعنا اليوم أن نرى ونسمع العالم قاطبة دونما وساطة الإشارة والرمز، وأن تكون حاضرين في كل مكان من المعمورة في آن واحد، وهكذا يتاح للأطفال والشبان أن يكونوا على اتصال مباشر بمشاهد من الحياة وبنماذج من السلوك تشغل في تجربتهم حيزًا أهم بما لا يقاس من الحيز الذي تشغله الأسرة أو الكنيسة أو المدرسة.
وهكذا، فإن “سرعة طواف” الحضارة، التي ظلت شبه ثابتة طوال ستة آلاف عام، تتخطى على حين بغتة عتبة جديدة في مختلف المجالات في منتصف القرن العشرين.
وقد ولد الجيل الشاب الراهن في تلك اللحظة من انعطاف التاريخ، ومشكلاته ليست بمشكلات أي جيل سابق، ولا حتى مشكلاتنا يوم كنا في العشرين من العمر.
فكيف يمكن، والحالة هذه، أن تأخذنا الدهشة إذا كان رد فعله الأول رفضًا شاملًا لأجوبتنا المعدّة سلفًا ولمؤسساتنا وقيمنا؟ ولعله من الأجدى لنا، بدلًا من أن نغتاظ من هذا الرفض، أن نتساءل عما إذا كانت أجوبتنا ما تزال مطابقة لهذه الأسئلة المستجدة، وعما إذا كانت مؤسساتنا ما تزال متكيفة مع المهام الجديدة، وما إذا كانت “قيمنا” ما تزال جديرة بأن ندافع عنها أو عما إذا كانت الحياة قد تجاوزتها، ولنعترف للشبيبة بهذا الجميل: فلقد وعينا، بفضل عنف ردود أفعالها، ضرورة وضع مجمل نمط حياتنا موضع تساؤل من قبلنا نحن أيضًا.
والمؤسسات الأقدم عهدًا هي الموضوعة اليوم موضع الاستجواب الأكثر جذرية: الأسرة، الكنيسة، الدولة، المدرسة، مفاهيم العمل والملكية والسياسة والأخلاق والثقافة والفنون.
ولنحاول بادئ ذي بدء، من دون أن نصدر حكمًا قيمة، أن نصف الطريقة التي تتصور بها الشيبة هذا كله وتحياه.
1- ما تفضحه
إن الأهل رمز انتقال نماذج السلوك، وعليه، فالنفي الأول هو نفي الأسرة، والتمرد الأول إنما هو موجه ضدها.
يكشف استبار قام به المعهد الفرنسي للرأي العام الستار عن هذه الحقيقة القاسية: إن 7% من الأشخاص الذين طرح عليه السؤال يجهلون ما إذا كان آباؤهم وأمهاتهم ما يزالون على قيد الحياة.
وردًا على السؤال الذي طرح على حوالي خمسة آلاف فتى وفتاة من التعليم التقني أو من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والعشرين: “هل تفضلون أن تمضوا قسطًا من عطلتكم الصيفية في العمل من أجل أوقات فراغكم أم أن تطلبوا المال من أسرتكم؟”، أجاب 85%: “نفضل العمل”، وذلك للابتعاد عن أسرهم، وللاحتكاك بوسط مغاير، ولإنفاق ذلك المال بحرية على أوقات فراغهم في آن واحد.
لقد أفرغت الأسرة في الأقطار الصناعية شيئًا فشيئًا من محتواها: فهي لم تعد وحدة عمل كما في المجتمعات الزراعية أو الحرفية، ولم تعد مركر تربية تقنية أو أخلاقية، أما بصفتها وحدة سكن ووحدة استهلاك فهي لم تعد تمثل في نظر الشبيبة “قيمة”، وكم بالأحرى سلطة. والتلاحم القديم الذي كان قد أمكن الوصول اليه بفضل التقاليد، ثم بفضل المال، ثم بحكم القانون، ما عادت الشبيبة تحيا إلا في شكل قمع لا مسوغ حياتيًا له.
وما ارتفاع نسبة الطلاق بين الشبان (40% طلقوا في العام الأول من الزواج في جامعات كاليفورنيا) إلا وجه آخر للظاهرة نفسها: فالاستقرار الزوجي والوفاء مدي الحياة يبدوان لهم عادة بالية ومفقرة في سياق التحول المتواصل لمجمل شروط الوجود ومشكلاته، ويرى هذا الجيل في الغيرة علامة تملك أكثر مما يرى فيها علامة حب، والأسرة لم تعد تلك الرابطة المتميزة الأثرة، وإنه لأمر له دلالته أن يكون حب المحارم، تلك الخطيئة الخطيرة في جميع المجتمعات التقليدية ابتداء من أوديب وحتى أواسط القرن العشرين، قد انتهى بقهقهة مدوية في فيلم لوي مال “القلب اللاهث”(2).
وفي مثل هذه الحال يصبح الجنسي، خارج سياق الأسرة التقليدي، بلا حماية، ولقد أماط فرويد اللثام، ابتداء من الصف الأول من قرننا، عن الدور الذي يلعبه قمع الجنس في تنظيم الحضارة بأسرها، ورفض الحضارة في مجملها يشدد اللهجة على رفض المحرمات الجنسية، والجسد هو الذي تمرد أولًا، ثم اقتفى العقل أثره في تمرده.
ومن اللغو الباطل اتهام حبوب منع الحمل بأنها هي التي تسببت في الفوضى الجنسية، فهي قد سلطت الضوء فقط على هشاشة “الأخلاق” المبنية على الخوف من النتائج الاقتصادية أو الاجتماعية لأفعالنا، أما المجادلات الدينية والأخلاقية والسياسية التي كانت تدور قبل عشرة أعوام حول التحديد الواعي للنسل فهي تبدو للفتى أو الفتاة البالغين من العمر العشرين في عام ۱۹۷۲ مجادلات لا تقلّ عقمًا ولغوًا على الخصومات البيزنطية بصدد جنس الملائكة.
إن الشبيبة، حين ترفض الاندماج بنظام للإنتاج والاستهلاك يفتقر الى الغائية الإنسانية، لا تطالب كما كان يطالب برغسون بـ”علاوة روحية”، بل تطالب على العكس، حتى تفجر المجتمعات التي تتحكم بها متطلبات مجردة، لا انسانية، كمتطلبات النمو للنمو والتقنية للتقنية، أقول: تطالب بجسد و بنهاية ثنائية الروح والجسد التي هي في آن واحد رمز وتبرير لجميع أشكال الثنائيات الأخرى ولجميع أنواع القمع الأخرى.
***
إن تطلع الشبيبة هنا إلى مقاطعة النظام وتجاوزه لا يتجلى بأعظم الوضوح كما يتجلى في معارضة الجامعة ومعارضة المدرسة بوجه عام.
ولقد كان عام ۱۹۹۸ هو العام المشهود لهذا الاحتجاج ولهذه الآمال، ولكن الأزمة بدأت قبل 1986، ونظرًا إلى أن أي مشكلة -في أي قطر- لم تحل في ذلك العام، فإن الأزمة ظلت مفتوحة بالرغم من خيبات الأمل وأعمال القمع.
إن كل مدرس، على أي مستوى، يستطيع أن يشهد على أنه يلاقي صعوبات متزايدة، وعلى أن مهمته قد تصبح مستحيلة تمامًا في مستقبل قريب أو بعيد.
وليست الجامعة هي وحدها التي وضعت في قفص الاتهام، وإنما النظام المدرسي في مجمله، فالشبيبة تتساءل عن مضمون المعرفة والثقافة وقيمتها، عن الدور الاجتماعي للتعليم، عن بنى المؤسسة الجامعية والمدرسية، والصبوات على هذه المستويات الثلاثة مبهمة في تعبيرها، ولكن اتجاهها العميق لا يقبل التباسًا.
وسوف نكتفي هنا برسم الخطوط العريضة البارزة لهذا النقد الجذري.
***
إن تشكيك الشبيبة في مضمون وقيمة المعرفة التي تُلقن إياها يبدأ مع الشك الذي يزرعه فيها عدد معين من الأساطير الضرورية للحفاظ على الأوضاع القائمة.
ولو محصنًا الأدب “المعارض” سواء أكان أدب جامعة نانتير أم السوربون في عام 1986، أدب برلين أم طوكيو أم بيركلي أم أمريكا اللاتينية أم أيطاليا، لوجدنا أن الموضوعة الغالبة فيه هي أن المعرفة التي تقدم للشبيبة تخفي الواقع بدلًا من أن تكشفه.
و”العلوم الإنسانية”، من هذه الزاوية نموذجية, فالاهتمام بتمويه كل أثر للتناقض في مجتمعاتنا يتطرف في هذه العلوم إلى أقصى مداه، وقد أعلن طلاب علم الاجتماع في جامعة أمستردام في عام 1986 عن محاضرة بعنوان: “هل ينبغي أن يكون علم الإجماع علمًا إنسانيًا؟”، وكان رأيهم أن علم الاجتماع والاقتصاد السياسي وعلم النفس ليست علوم إنسانية إذا ما اخذت بعين الاعتبار الطريقة التي تدرس بها على وجه العموم في الجامعات وإنما هي محض توابع فقيرة لعلوم الطبيعة، فعلماء الاجتماع وعلماء النفس ينظرون بوجه عام إلى الكائنات الانسانية نظرتهم إلى مستعمرة من الجرذان في محاولتهم تحديد سلوكها وقياسه، وكل ما هنالك أن درجة أعلى من التركيب أو التعقيد تبرز على مستوى المجتمعات الإنسانية أو الأفراد الإنسانيين، وعليه فإن العلوم المسماة بـ”الإنسانية”، تستخدم نفس منهج علوم الطبيعة ولها بوجه خاص غرضها نفسه: التحكم بالظاهرات التي هي هنا بشر.
يشير علماء اجتماع نانتير الشباب، من طلبة وأساتذة، في مذكرة عن الدور الاجتماعي لعلم الاجتماع في عام 1986، إلى أن الغرض الأساسي لعلم الاجتماع الصناعي هو تكييف العامل مع وظيفته، وإلى أن علم الاجتماع السياسي يزيف مفهوم السياسة بالذات إذ يركز الأبحاث على الاختيار الانتخابي كما لو أنه المحرك الحقيقي للحياة السياسية، وإلى أن علم الاجتماع المطبق على الدعاية هي تقنية تحكم وتكييف، وإلى أن الخطط البوليسية التي أعدها وزير دفاع الولايات المتحدة، ماكنمارا، لمكافحة ثوار أميركا اللاتينية تحت اسم المشروع كاملوت، قدمت للجمهور على أنها “برنامج دراسات سوسيولوجية”.
وفي نفس العام طرح علماء النفسي الشبان في السوربون سؤالًا مماثلًا على أنفسهم: “هل يمكن لعالم النفس أن يكون أداة (تكييف) أفضل مع نظام استلابي في ذاته؟”.
ولا غرو أن تكون حركة 1968 في فرنسا قد بدأت على وجه التحديد في قطاعات على الاجتماع وعلم النفس والفلسفة: فهنا يبرز أكثر من أي مكان آخر أن نفاق “الموضوعية العلمية” المزعومة يفيد في التستر على تقنيات التحكم والتلاعب بالبشر لتسهيل “إدارة” المشاريع وحكم الدول.
إن العلوم الانسانية المفهومة على هذا النحو تؤلف جزءا لا يتجزأ من مجتمع قمعي.
وبعد مأخذ حجب الواقع بدلًا من كشفه تأتي تهمة تدمير الشخصية بدلًا من تطويرها.
أفليس غرض التعليم الراهن دمج الطفل لإعداده لوظيفة في الإنتاج أو في الدولة؟ ألا تهدف المدرسة ثم الجامعة إلى تأسيس هرم مسلسل من الوظائف والأدوار، وإلى قولية وتخصيص كل فرد لكي يصبح نموذج الفرد الذي يحتاجه هذا المجتمع؟ فكيف تأخذنا الدهشة، والحالة هذه، إذا ما وجدنا الشبيبة تشعر بالاختناق في هذه الآلاف من الصناديق الصغيرة المسبقة الصنع التي يتوجب على كل فرد أن يدلف اليها ويبقى فيها؟
كيف تنظر الشبيبة إلى العلم الذي لا تؤكده إلا شهادة تبيح لحاملها أن تحتل مكانه في ذلك الصندوق الصغير وأن يتلقى أجرًا أو راتبًا، وفي حال عمله في الوظيفة العمومية أن يستغلها كما تستغل براءة اختراع؟ شهادة تخلق أحيانًا متقاعدين في سن الخامسة والعشرين؟ إن هذا العلم لا يبدو نشاطًا شخصيًا بل بضاعة: فمرتبة الفرد الاجتماعية تقاس غالبًا بكمية التعليم الذي استهلكه، وعليه فإن العلم أشبه ما يكون بالعملة، وقد حلل مارکس استلاب العامل في المجتمع الطبقي، وتطور صنمية البضاعة التي هي أساس هذا المجتمع والتي تتعمق وتتفاقم مع الانتقال من البضاعة الى المال ومن المال إلى الرأسمال، وشبيبتنا تفضح ظاهرة مماثلة في العلم: فهذا العلم هو الآخر علم مستلب، أي أنه ليس عملًا خلاقًا للإنسان، بل شيء خارجي عن الفرد و متعالٍ عليه، لا صلة له بحاجاته الذاتية وبتطلعاته إلى تفتح شخصي.
إن أحد المطالب الأساسية ضد علم التربية الذي يدمج الشبان بمنطق النظام هو المطالبة ببحث يتم معهم، بل من قبلهم، لا من أجلهم.
وأيًا تكن أشكال هذا المطلب، الطوباوية أحيانا، فإنه يتطلع إلى نضال ضد لاإنسانية العلم واستلابه، وتحت شعار “الجامعة النقدية” يطل الطموح الى تربية تساعد لا على تمويه التناقضات والاستغلالات والاضطهادات بل على وعي حقيقة أن النظام الحالي ليس هو النظام الوحيد الممكن، وليس علمًا مغلقًا لا منفذ له، وليس عالمًا ضروريًا لا غنى عنه، وإنما هو على العكس وضع حد البشر ويقيدهم، وفي المستطاع تغييره.