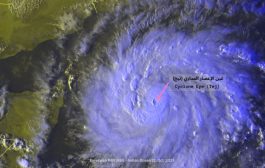عيبان محمد السامعي
“ورقة عمل مقدمة للندوة التي أقامتها “حملة جوازي بلا وصاية”، مدينة تعز، 3 فبراير 2022”
تتعرض المرأة في مجتمعنا الذكوري لعنف بنيوي مركب وشامل، تبدأ حلقاته من المستوى الخاص وتنتهي بالمستوى العام، بدءاً من الأسرة مروراً بالنظام التعليمي والقانوني والاقتصادي والديني والرمزي وليس انتهاءً بالنظام السياسي.
لقد كانت ولا زالت القوانين والممارسات الرسمية وغير الرسمية على علاقة خصومة دائمة مع النساء، إنها علاقة قهرية، علاقة الجلاد بالضحية. فالتشريعات والقوانين اليمنية ذكورية بامتياز وصيغت بطريقة تضع المرأة في مواقع القصور والدونية، وهو ما نجده في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات على نحو فج، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل الأنكى من ذلك أن تجد الأعراف الاجتماعية البالية تتسيد على القوانين وعلى الدستور [أبو القوانين]، وتمارس سلطتها القهرية على النساء.
إن الاشتراطات الإدارية التي تعيق المرأة اليمنية من الحصول على جواز السفر، إلا بموافقة ولي أمرها خلافاً للقانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن الجوازات والهجرة، ليست قضية هامشية أو جزئية كما يظن البعض، بل هي من صميم قضية المواطنة المتساوية، وقضية دولة النظام والقانون.
إن هذه الاشتراطات الإدارية تكشف في إحدى أبعادها أن سلطة العرف الاجتماعي تعلو على سلطة القانون، وأن مؤسسات الدولة المعنية بدرجة رئيسية بتطبيق القانون، هي من تقوم بتعطيله لصالح الاستناد إلى سلطة العرف التقليدي وسلطان النظام الأبوي المتخلف، وكأنّ الشغل الشاغل لهذه المؤسسات هو العمل على محاصرة المرأة وفرض الوصاية عليها وتهميشها وحرمانها من أبسط حقوقها.
إن الهدف من هذه الإجراءات والاشتراطات الجائرة هو تأبيد استعباد المرأة وقطع الطريق أمام امتلاك مصيرها وتحررها الإنساني، لأن حرية التنقل والسفر بدون قيود هي التجسيد العملي لقيمة الحرية، وهي من المبادئ الأساسية التي تكفلها الدساتير والقوانين.
لقد عرّفت الفيلسوفة الألمانية حنة آرنت الحرية بأنها: “حالة الإنسان الحر الذي يتاح له الانتقال والخروج والذهاب في العالم، ومصادفة أشخاص آخرين”. وما قيمة الحرية إذا لم يكن الإنسان قادر على التنقل والسفر بدون قيود؟!
إن الحرية تحيلُ إلى الحركة، أي الخروج من هنا، والذهاب خطوة أبعد من المعتاد، واستكشاف فضاء أوسع غير معلوم مسبقاً… في حين أن الحبس هو المنع من الحركة، أو تقييدها في نطاق معين.
الحرية في الأساس هي حركة غير مُعاقة، أو غير محجوزة، بينما السجن هو الحركة المقيدة والمحجوزة.[1]
إذن حرية التنقل والسفر دون قيود هي ممارسة فعلية للحرية، وتعكس قدرة الفرد على امتلاك قراره، وعلى تحديد اختياراته المستقبلية، وعلى قدرته على الاعتماد على نفسه دون الحاجة إلى لوصاية أحد.
يترتب عن الإجراءات والاشتراطات المقيدة لحصول المرأة على جواز السفر والتي تتبعها مصلحة الجوازات والهجرة آثار وتداعيات مختلفة، فهي تؤدي إلى حرمان المرأة من الحق في التعليم النوعي “الذي يتطلب السفر إلى الخارج”، كما تؤدي إلى حرمان المرأة من الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية التي لا تتوفر في البلاد، وحرمانها من التمتع بالحقوق المهنية كالتأهيل والتدريب النوعي وتطوير المهارات والقدرات والخبرات، وهو ما ينعكس سلباً على تمتعها بحقها في الترقي المهني والوظيفي، كما تعمل على الحد من قدرة المرأة على المشاركة في الشأن العام وفي النشاط الاقتصادي والثقافي والعلمي… إلخ.
وهناك عشرات الشهادات لنساء واجهن صور من المعاناة المريرة للحصول على جواز السفر تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
في تقديري إن تناول مسألة تقييد حرية المرأة في الحركة والتنقل والحصول على جواز السفر بمعزل عن البعد الاجتماعي يظل تناول سطحي وجزئي ومرحلي ولا يفضي إلى نتائج حقيقية على صعيد مستقبل قضية المرأة وحقوقها الإنسانية وبناء الوعي الجديد. وهنا لا أجد أي مبرر منطقي لتهيُّب البعض من طرح قضية المرأة وتحررها من القيود التي يفرضها المجتمع الذكوري عليها، فطريق الحرية ليس مفروشاً بالورود، بل مفروش بالأشواك والعقبات والمصدات، و”الأيدي المرتعشة لا تصنع الحرية”.
إن مسألة تقييد حق المرأة في الحصول على جواز السفر تكشف في عمقها عن طبيعة النظام الأبوي ومنظومة الأعراف والمعايير التقليدية السائدة في مجتمعنا.
إن النظام الأبوي (Parental system)، وفقاً لعالمة الاجتماع والانثروبولوجيا غيردا ليرنر “هو تجلي ومأسسة للهيمنة الذكورية على النساء في الأسرة وفي المجتمع بصورة عامة”، ويقوم على تأكيد تفوق الذكر على الأنثى، فالأنثى ــ من منظور النظام الأبوي الجائر ــ شخصاً قاصراً وناقصاً عقلاً وديناً، وهي شرف العائلة ورمز عفتها. لهذا يفرض النظام الأبوي حصاراً عليها، ويتحكّم بتفاصيل حياتها، فهو من يسمح أو لا يسمح بخروجها من المنزل، وتنقلها، وهو من يقرر الحاقها بالتعليم ومن ثمّ بسوق العمل أو حرمانها من ذلك، وهو ــ أيضاً ــ من ينوب عنها في اتخاذ قرار زواجها واختيار شريك حياتها.
يشكّل النظام الأبوي “البطركي” البناء التحتي للمجتمع العربي، وفقاً للمفكر العربي هشام شرابي، وحجر الزاوية في هذا النظام تتمثل في “استعباد المرأة” و”العداء العميق والمستمر في لاوعي المجتمع للمرأة ونفي وجودها الاجتماعي كإنسان والوقوف بوجه كل محاولة لتحريرها.”
ولهذا يعتقد شرابي ـ وهو محق في ذلك ـ أن جذر التخلف الشامل الذي تسود مجتمعنا العربي يكمن في تسيّد النظام الأبوي.
يستند النظام الأبوي على إرث ثقافي ـ اجتماعي متجذر، ويتجسد في منظومة الأعراف والتقاليد والمعايير الاجتماعية التي تمتلك سلطة معنوية قاهرة على أفراد المجتمع لأنها تمارس عملية ضبط لسلوكهم وتصرفاتهم وتُخضِعهم لسلطانها، وأي خروج عن سلطانها يعرّض الفرد إلى النبذ والتحقير من قِبل المجتمع.
ويحدث غالباً أن يتضافر هذا الإرث التقليدي مع الخطاب الديني الظلامي فينتج عنها مركب كيميائي قمعي للمرأة. فالمرأة وفقاً لهذا المركب القمعي “عورة” و”مصدر الفتنة” ينبغي تحجيبها بدعوى تحصين المجتمع من “الفساد”.
ومن الملفت للانتباه أن مفردة “الفساد” في الخطاب الديني ــ عادةً ــ ما تُختزل في الجانب السلوكي الفردي فقط، ويتعامى هذا الخطاب عن الفساد السياسي، والفساد الاقتصادي، ونهب المال العام، والجوع، والفقر، والبطالة، والاستبداد، والتعذيب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقتل خارج إطار القانون، …إلخ وهنا بالضبط تكمن أزمة الخطاب الديني!
ولكي لا يلتبس الأمر على القارئ، نُسارع إلى التوضيح بإنّ الخطاب الديني لا يعني الدين، فهناك فرق كبير بين الخطاب الديني والنصوص الدينية. الخطاب الديني هو أفهام وتفسيرات رجال الدين للنص الديني، وليس بالضرورة أن تكون هذه الأفهام والتفسيرات مطابقة لروح الدين ومقاصده السامية.
إنّ واقع الحال يكشف عن وجود اتجاهات متباينة في الخطاب الديني إزاء العديد من القضايا ومنها قضية المرأة؛ فهناك الاتجاه التنويري وهناك الاتجاه المتطرف. ونحن حين نتحدث عن الخطاب الديني لا نقصده بعموميته، بل نقصد ذلك الاتجاه المتطرف الذي يغالي في العداء للمرأة ولحقوقها وللقيم العصرية.
إذن “الفساد” من منظور الخطاب المتطرف إنما يرتبط بطريقة لباس المرأة وبخروجها من المنزل وذهابها للعمل و”اختلاطها” بالآخرين!
هكذا ينتقص الخطاب المتطرف من المرأة، فهو ينظر إليها نظرة دونية، ويعتبرها كائن مشكوك فيه، ومحل إدانة، ومصدر الغواية والإغراء، وقاصر عن التحكّم في شهواته ورغباته، لذا يعمل على محاصرته وفرض وصاية عليه!
إنه خطاب ذكوري غرائزي بامتياز، خطاب لا يرى المرأة إلا من “خرم إبرة”، أو موضوعاً للجنس ووسيلة للمتعة، ولا يراها إنساناً مكتملاً له هوية مستقلة وكيان خاص، وله طموحات وآمال وتطلعات.

تُحاصر الأنثى في مجتمعنا الذكوري بالتابوهات والمحرمات وقيم العيب والعار، وتظل حبيسة تلك القيم منذ ميلادها وحتى وفاتها، ويتم تنشئتها على أنها رمز العفة وعنوان الشرف، ويقع على عاتقها الحفاظ على سُمعة العائلة.
وتحت وطأة ضغط منظومة القيم والمعايير هذه، يجري تطويع النساء للهيمنة الذكورية، عبر “العنف الرمزي” كما يؤكد عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، والعنف الرمزي هو ذلك العنف الناعم واللامحسوس واللامرئي من قبل الضحايا، ويمارس تزييف للوعي، لدرجة أن تستدمج الضحية هذه الهيمنة وتستجيب لها بشكل شعوري أو لا شعوري.
ويظهر هذا الأمر لدى بعض النساء الواقعات تحت تأثير الأيديولوجيا الدينية – السياسية أو تأثير التنشئة الاجتماعية الخاطئة التي تسوّغ أشكال اضطهاد المرأة من منطلق ديني ــ ثقافي.
ليس عجبًا أن تجد هذا الصنف من النساء يتخذنَّ مواقف وينخرطنَّ في ممارسات هي على الضد من مصالحهنَّ وحقوقهنَّ كنساء، مثلاً: أن يناصرنَّ القيود الإدارية التي تتبعها مصلحة الجوازات والهجرة والتي تشترط منح جواز السفر للمرأة بموافقة ولي الأمر، أو أن يتخذنَّ موقفاً مؤيداً لزواج القاصرات، أو يقفنَّ ضد الكوتا النسوية، وضد المساواة بين الجنسين، باسم “الدفاع عن الشريعة” و”حماية الفضيلة” و”مناهضة العلمانية”، و”محاربة الفساد الأخلاقي”!
إنّها صورة فجة من الرثاثة، والتعاطي معها لا يكون بإدانتها والسخرية منها أو التعالي عليها، بل يتطلب الأمر نهجاً مختلفاً، يقوم على أساس كشف زيف الأيديولوجيا المسيطرة على الضحايا من النساء، ومخاطرها على أنفسهنّ وعلى أدوارهنّ وقيمتهنّ الإنسانية.
وعوداً إلى الحديث عن التشريعات والقوانين وعلاقته بحقوق المرأة، نؤكد على أن التشريع هو الأساس في إضفاء طابع المشروعية لأي عمل أو سلوك اجتماعي، نظراً لما يحدده من حقوق وواجبات وبما يفرضه من عقوبات.
لقد كفل دستور اليمن الموحد المستفتى عليه عام 1991 الحقوق الإنسانية للمرأة ومساواتها مع الرجل، فقد نصت المادة (27) من دستور 1991 على أن “المواطنون والمواطنات جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب النوع أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي”. غير أن التعديلات الدستورية لعام 1994 قد ألغت هذه المادة واستبدلتها بمادة أخرى تنص على أن: “النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وما ينص عليه القانون.”
وقد مثلّت هذه المادة انتقاصاً للحقوق الإنسانية للمرأة لأنها عرّفت النساء بدلالة الرجال، وكأنّ النساء لا يوجد لهنَّ هوية مستقلة ولا وجود كياني بدون الرجال. إنَّ هذه المادة تعد من أخطر المواد لأنها تكرِّس بنص دستوري السلطة الذكورية على المرأة وتجعل منها تابعاً ومُلحقاً بالرجل، وحسناً فعلت مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي عندما أعادت العمل بنص المادة الواردة في دستور 1991.
وأما قانون الأحوال الشخصية رقم (34) لسنة 2003، في المادة (40) فقرة (4) تنص على:
“عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذن الزوج أو لعذر شرعي أو ما جرى العرف عليه بما ليس فيه إخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعليها حق الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافي مع الشرع”.
هنا يتضح بشكل فاضح كيف تتساند بعض النصوص القانونية مع نسق العرف الاجتماعي ضداً على المرأة وعلى إنسانيتها.

إن قانون الأحوال الشخصية قد صِيغَ “صياغة ذكورية، واتخذ من العرف القبلي وقيمة الشرف مرجعية لكل حقوق المرأة، ولأن كل الحقوق ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالحق في الحركة، ولا يمكن التمتع بها دون أن تكون المرأة متمتعة بالحق في الحركة، فالحق في التعليم والصحة وجميع الحقوق المدنية والسياسية، لا يمكن للمرأة أن تتمتع بها، دون أن تتمتع بالحق في الحركة، وقد قيّد قانون الأحوال الشخصية اليمني حق المرأة في الحركة بموافقة الزوج، وبالتالي فإن تمتع المرأة المتزوجة بأي حق من حقوق المواطنة بشكل خاص، وحقوق الإنسان بشكلٍ عام، يغدو مرهوناً بموافقة الزوج.”[3]
إن المجتمع الذكوري يخاف من المرأة القوية، المرأة المستقلة، المرأة الصانعة لهويتها والمالكة لمصيرها، ولهذا يعمل المجتمع الذكوري بكل ما يتسنى له من أدوات إكراهية وتحايُلية لإخضاع المرأة وقهرها واستعبادها، وفي هذا المقام يذهب المفكر اليمني الكبير د. أبوبكر السقاف إلى اعتبار الأسرة الأبوية مدرسة القهر الأولى، ففيها تُعَدُّ الإناث ليقبلن القهر قيمة داخلية يحملنها في صميم شخصيتهن، (…) إن تحطم كل نزوع نحو الاستقلال يبدأ في الأسرة، ولا سيما عند الفتيات، فالأسرة الأبوية أول وأخطر بنية للنظام الاجتماعي القائم، فهي التي تكوِّن عند الأطفال تركيباً في الطبع، والشخصية يجعلهم فيما بعد قابلين للتأثر بنظام اجتماعي متسلط، والرضوخ له هي السمة السائدة. [4]
ما العمل إذن؟؟
لا سبيل أمام النساء ومناصريهنَّ من الرجال سوى مواجهة هذه المنظومة المعقدة التي تنتقص من الحقوق الإنسانية للمرأة وتنتهك آدميتها.
إنّ قضية المرأة ليست قضية جزئية/ هامشية أو قضية تخص المرأة وحدها، بل هي قضية المجتمع ككل، بل قضية الإنسانية بصورة عامة. وتحرير المرأة من القيود التي تكبّلها لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار تحرير المجتمع من التمييز الجندري والتخلف الاجتماعي والتفاوت الطبقي والاستبداد السياسي وهيمنة الإرث الثقافي التقليدي والتصورات الدينية الظلامية، أي بإحداث تحويل جذري باتجاه سيادة المواطنة المتساوية والديمقراطية والتنمية الشاملة المستدامة والقيم الإنسانية الرحبة.
الهوامش والإحالات:
[1] ياسين الحاج صالح، الحرية: البيت، السجن، المنفى… العالم، “مقال”، جريدة الجمهورية، متاح على الانترنت.
[2] ميسون العتوم، ملاحظات أولية حول المرأة الأردنية وبناء الشخصية، مجلة إضافات، بيروت، الجمعية العربية لعلم الاجتماع، العدد 19، صيف 2012، ص77.
[3] عادل مجاهد الشرجبي وآخرون، القصر والديوان، الدور السياسي للقبيلة في اليمن، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، أكتوبر 2009، صص141-142، “بتصرف”.
[4] راجع: أبوبكر السقاف، الجمهورية بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالي، صنعاء، 2020، ص142.