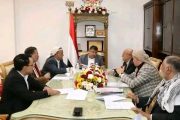كتاب المواطن / سلامة كيلة
هل يستقر حكم الإسلاميين؟
إذا كان الظرف الموضوعي هو الذي فرض أن يصبح الإسلاميون هم السلطة، سواء نتيجة غياب البدائل السياسية التي تعبر عن الشعب، أو نتيجة كل التكتيكات التي اتبعت من أجل أن يكونوا هم “الشكل الجديد” للسلطة. فإن السؤال الذي يطرح هنا هو: هل يمتلك الإسلاميون حلولًا لمجمل المشكلات التي فجرت الثورات؟ أو هل يمكن لهم أن يحكموا دون تحقيق المطالب التي كانت في أساس الحراك الشعبي الذي فجّر الثورات، والتي لم يكونوا يطرحونها أصلًا؟
ما يبدو واضحًا هو أن الإسلاميين لا يمتلكون برنامجًا يتضمن حلولًا للمشكلات المجتمعية، وإذا كانوا معارضين للنظم السابقة فذلك لم ينتج عن اختلاف عميق معها في كثير من المسائل الجوهرية، وربما كان تخوف النظم من ما كان يشاع عن دعم أميركي لإشراك هؤلاء في السلطة هو الشكل الأبرز للاختلاف الذي كان يظهر بينهم، رغم أن الإسلاميين دعموا الكثير من المواقف والقرارات الاقتصادية والسياسية لها، وإن التدقيق في “الصراعات العملية” يشير إلى ميل “رجال الأعمال الجدد” (أي المافيا المتشكلة حول عائلة الرئيس) إلى السيطرة الشاملة على الاقتصاد المحلي، وبالتالي تدمير كل الفئات الرأسمالية الأخرى أو “هضمها”، الأمر الذي جعل الصراع حتميًا بين الطرفين، كون القاعدة الأساسية للإسلاميين كانت من فئات تجارية “تقليدية” (أو حتى مافياوية، مثل شركات توظيف الأموال مثلًا).
فالأساس الاقتصادي الذي يطرحه الإسلاميون ينطلق من حرية التملك، ورفض المصادرة، كما ينطلق من التركيز على التجارة كون فيها “تسعة أعشار الربح” كما أدعى أبو حامد الغزالي، وليس ذلك غريبًا عن منطقهم، حيث تشكل ما عرف بـ”الإسلام السني” بعيد بدء انهيار الإمبراطورية العربية الإسلامية، وتقوقع المدن التي باتت مراكز تجارية، ومن ثم تشكل كمعبّر عن هؤلاء، ولقد اتخذ طابعًا محافظًا تأسيسًا على ذلك، وتمركز حول “الأحكام الأخلاقية”. هذا ما بدأ مع أبو حامد الغزالي، ممتدًا إلى ابن تيمية وابن القيم الجوزية، وصولًا إلى محمد بن عبدالوهاب وتبلور جماعة الإخوان المسلمين التي اعتمدت في تشكلها على الوهابية كذلك.
لهذا وجدنا أن جماعة الإخوان المسلمين تدعم قرارات حسني مبارك فيما يتعلق بإلغاء التأميم وتعميم الخصخصة، وكذلك القرارات التي صدرت بخصوص الأرض وأقرت بإعادة الأرض إلى الإقطاعيين القدامى وتشريد الفلاحين، وما عبرت عنه الجماعة بعد الثورة وخصوصًا بعد سيطرتها على مجلسي الشعب والشورى، حيث أكد أكثر من مسؤول فيها أن الجماعة لم تختلف مع حسني مبارك في سياسته الاقتصادية، وأيضًا هذا ما تردد على ألسنة قيادات في حركة النهضة التونسية، حيث جرى القول إن الحركة لم تختلف مع بن علي في سياسته الاقتصادية، ولهذا وجدنا السلطة الجديدة في البلدين تونس ومصر، تمارس السياسات ذاتها في المجال الاقتصادي، مثل الاعتماد على قروض صندوق النقد الدولي، والسعي لتقديم تسهيلات لجلب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك رفض تحديد حد أدنى للأجور، أو إيجاد مداخل لحل أزمة البطالة، أو التفكير في تحسين التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما لم يظهر أنها تعمل على تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية، حيث أخذت تمد السيطرة على مؤسسات الدولة، وتفرض سطوتها على الإعلام، وتعود لقمع الحراك الشعبي، وتشن هجومًا على الإضرابات تحت حجة رفض “المطالب الفئوية”.
بمعنى أن السلطة الجديدة كرست النمط الاقتصادي الذي تشكل في العقود التالية للناصرية في مصر، وعززت من السياسات الليبرالية في كل من مصر وتونس، وهو ما يمكن أن تفعله أنى نجحت في أن تكون هي السلطة الجديدة.
لهذا يمكن التأكيد على أنها لا تحمل حلولًا لمشكلات البطالة وتدني الأجر وانهيار التعليم والصحة والبنية التحتية، كما لا يمكن ضمان أن تكون ديمقراطية، وأن تؤسس دولة مدنية ديمقراطية كما طالب الشعب في ثورته، فقد عادت للكلام عن “الخلافة الإسلامية”، وأخذت توحي بضرورة تطبيق الشريعة، وتعمم بأن وصولها السلطة هو نتاج تحقق “وعد إلهي” سوف يقود إلى سيطرتها على “ديار المسلمين”.
ما هو مهم هنا هو أن “مشروع النهضة” الذي طرحته لا يحمل حلولًا للمشكلات التي كانت في أساس تفجر الثورات: البطالة والأجر المتدني، وهي المطالب التي كانت في أساس تفجر الثورة التونسية، ومن جملة مطالب الثورة المصرية، وكل الثورات العربية، ولا في تأسيس الدولة المدنية التي كانت هي الأخرى مطلبًا واضحًا في هذه الثورات.
بالتالي هل يمكن أن يلوذ الشعب بالصمت معتبرًا أن ثورته قد فشلت أو سرقت، وأنه لم يجنِ سوى وصول الإسلاميين إلى السلطة؟
هذه النقطة تغيب عادة عن البحث أو يعتبر أن فشل الثورة قد حصل، لكن هل يمكن للذين تمردوا بعد أن أصبحوا عاجزين عن تحمل الوضع الذي يعيشونه أن يعودوا إلى قبول الوضع ذاته؟
الحراك المستمر يشير إلى أن الأمر مختلف، حيث إنه ليس من الممكن أن يجري التراجع بعد أن أصبح الواقع ذاته لا يسمح بالعيش، وبعد أن امتلك هؤلاء الجرأة وتسيس قطاع كبير من الشباب الذي كان منكفئًا أو منعزلًا، بمعنى أن سلطة الإسلاميين سوف تكون عرضة لاحتجاجات متتالية كبيرة، ربما تخفت قليلًا لكنها سرعان ما تعود بقوة، وبالتالي أن تكون هي ذاتها سلطة مهزوزة وضعيفة، ربما تحاول أن “تضرب بقوة” لكن دون مقدرة على الحسم، ودون مقدرة على ضبط الوضع الشعبي المتحرك، لهذا ستبقى سلطة ضعيفة وعرضة للانهيار والعجز عن الحكم.
الإسلاميون الآن في تجربة قاسية، هم ليسوا قادرين على الخروج منها منتصرين، لأنهم بالضبط لا يمتلكون الأساس الذي يسمح بذلك، وهو الحلول لمشكلات مجتمعية كبيرة تراكمت طيلة عقود، ولوضع اقتصادي طبقي يفرض تغيير كلية النمط الاقتصادي، في حين أن رؤيتهم الاقتصادية لا تخرج عن تكرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الدراجة، والتي كان تطبيقها منذ الانفتاح الاقتصادي الذي قام به أنور السادات في مصر ومنذ قبول شروط صندوق النقد الدولي واعتماد الخصخصة والاتكاء على الديون, كان تطبيقها هو الذي فجر هذه الثورات، بعد أن أوصل الشعب إلى حالة من التهميش شديدة القسوة.
لهذا ستكون سلطة فاشلة وستفضي سياستها إلى عودة الغضب الشعبي، ولن يقف الدين حاجزًا أمام تصاعد هذا الغضب، لأن مقياس الشعب عملي وليس روحيًا، ويتعلق بالحلول التي تقود إلى تجاوزه لوضعه الراهن، الذي بات لا يمتلك ترف التخلي عن النشاط من أجل تجاوزه.
ربما كان على السياسة أن تفهم الآن أنها من صنع الشعب وليس من صنع النخب التي يمكن أن تتوه خلف تخوفات وتوهمات، وتقديرات ليست مبنية على فهم حقيقي للواقع، ولمعنى أن يثور الشعب، ليس من خوف من سلطة أصولية قوية وطويلة، بل نحن في لحظات تلاشي مشروع الإسلام السياسي.
عن رهاب النخب:
الخوف من الإسلاميين:
في العقود الماضية انتشر الخوف من الإسلاميين الذين أصبحوا قوة حقيقية بعد أن أصبح “الإسلام السياسي” يعتبر قوة المعارضة الأساسية للنظم، لكن هذا الخوف تصاعد بعد الثورات في البلدان العربية، ويمكن القول إن حالة رهاب تتحكم في قطاعات “مدنية” من اليسار إلى العلمانيين، وتقود إلى تضبيط الصراع كصراع “مدني/ديني”.
ورغم كل نقاط الضعف التي ظهرت بعد وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في تونس ومصر (وحتى المغرب) من خلال الانتخاب، لازال الخوف يسيطر على هؤلاء، على العكس فقد تصاعد إلى حد القناعة بأن الإسلاميين يعملون على السيطرة الشاملة، وأنهم سوف يسيطرون لسنوات طوال؛ لهذا يشار إلى أن “الربيع العربي” قد انقلب إلى “خريف إسلامي”، الأمر الذي فرض الميل لتقليل الاهتمام بالحراك الشعبي، وحتى التشكيك فيه، وأيضًا الميل إلى اعتبار أن الصراع “الأساسي” بات مع الإخوان المسلمين، وأن “الحلقة المركزية” (هذا المصطلح الذي عممته الماركسية السوفييتية) تتمثل في مواجهتهم والتأكيد على أن الصراع الآن هو صراع بين دعاة الدولة المدنية ودعاة الدولة الدينية، وأن كل التحالفات يجب أن تبنى على أساس هذا الاصطفاف.
هل من خوف من أن يسيطر الإسلاميون؟ أو أن يتحكموا بالسلطة لعقود؟
ربما كانت تجارب إيران مع سيطرة الخميني ورجال الدين وتحكمهم في السلطة منذ سنة 1979، وسيطرة الإسلاميين على السلطة في السودان واستمرارهم فيها منذ سنة 1989، تؤسس لخوف عميق من تكرار هذه التجارب، طبعًا دون تلمس اختلاف الظروف المحلية والعالمية، وخصوصًا أن وصول هؤلاء إلى السلطة الآن مرتبط بالوضع الذي أوجدته الثورات، والذي بالضرورة سيرتبط بوضع الثورات ذاتها، فالثورات بدأت ولم تنته بعد، ولكي يستقر الوضع يجب تحقيق تغيير اقتصادي يقود إلى حل مشكلات قطاع كبير من الشعب فيما يتعلق بالعمل والأجر والتعليم والصحة والخدمات، وأيضًا الدولة المدنية، ولهذا نقول إن الإسلاميين هم الآن أمام مأزق حاسم لا حل له، يتمثل في أنهم لا يملكون الرؤية ولا المصلحة فيما يسمح بحل كل هذه المشكلات، لأن الحل اقتصادي ويقوم على تجاوز النمط الذي كرسته النظم السابقة كاقتصاد ريعي متحكم فيه من قبل فئة مافياوية عائلية، ينما يؤكد الإسلاميون على الاقتصاد الريعي عبر تكريس النشاط التجاري والخدمي والمالي، ورفض النشاط الصناعي والزراعي، إنهم ليبراليون في زي إسلامي وهم ليبراليون بالمعنى الذي تكرس في إطار العولمة بالتحديد، أي كمافيا.
هذا الأمر يفرض بالضرورة ألا يستطيعوا امتصاص احتقان الشعب، وسيصبحون هم واجهة الصراع الطبقي، هم الفئة من الطبقة الرأسمالية التي يخوض الشعب الصراع ضدها بعد أن وصلت إلى السلطة.