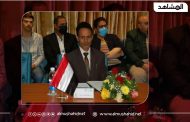المواطن/ كتابات – جلال أمين
فى سنة ١٩٨٢، أى منذ ثلث قرن، تلقيت دعوة من مدير جامعة صنعاء (الدكتور عبدالعزيز المقالح) للقدوم إلى صنعاء، لألقى بضع محاضرات عامة، أقوم أنا باختيار موضوعها. والدكتور المقالح شاعر معروف، ومثقف كبير، تلقى تعليمه الجامعى فى القاهرة، وعاد إلى صنعاء ليشترك فى بناء نهضة جديدة فى بلاده بعد ثورة ١٩٦٢، التى كانت مجلة بريطانية قد وصفتها عند قيامها، بأنها ثورة تهدف إلى إخراج اليمن من العصور الوسطى.
قبلت الدعوة سعيدا، إذ تتيح لى رؤية اليمن لأول مرة، فإذا بى أقع فى حب صنعاء من أول نظرة، ولازلت أحمل لليمن هذا الشعور القوى، رغم مرور كل هذا الزمن، ورغم أنى لم أزرها قط منذ تلك الزيارة الأولى. ولهذا يصيبنى الحزن الشديد كلما سمعت عن قتال بين يمنيين، فريق منهم ضد آخر، أو بين اليمن ودولة خارجية، أو عن انفصال جنوبها عن شمالها، أو عن تعثر محاولتها لتحقيق التقدم الاقتصادى الذى كنا نعلق عليه الآمال.
شعرت فى تلك الزيارة بأن العاصمة اليمنية جديرة بأن تكون أقرب إلى قلب المصرى من أية عاصمة عربية أخرى. وأسبابى لا تتعلق بالمعمار اليمنى الجميل، أو بجو اليمن أو تاريخها.. إلخ، فكل هذا قد يبهر الأوروبى أو الأمريكى بنفس القدر الذى يبهر المصرى. وإنما كانت لدى أسباب مصيرية صرفة.
هناك قول مأثور للإمام الشافعى «لابد من صنعاء وإن طال السفر»، وهو قول لابد أنه يتردد على سمع الطفل اليمنى الصغير عشرات المرات، كما يتردد على سمع الطفل المصرى أن مصر هبة النيل أو أن مصر أم الدنيا. ولا أعرف بالضبط لماذا قال الإمام الشافعى ذلك، هل لأن طريق التجارة كان لابد أن ينتهى بصنعاء؟ أم لأن طلاب العلم والحكمة كان لابد أن ينتهوا بالجلوس إلى علماء صنعاء وفقهائها (مما يفسر أيضا قولا مأثورا آخر بأن «الحكمة يمانية»)؟
أيا كان الأمر فإن هناك أسبابا تجعل من الواجب على المصرى بالذات أن يرى صنعاء. فما كل هذا الحب الذى يكنه اليمنيون لمصر؟ إنى لا أقصد بالطبع «الحب الرسمى» الذى قد يظهر فى عناق رئيس الجمهورية لرئيس آخر، ولا هو مجرد أن تطلق دولة عربية اسم جمال عبدالناصر على أحد شوارعها (كما فعلت اليمن)، فهذا قرار تتخذه الحكومة أو البلدية، وقد تطلق عليه اسما آخر غدا. ولكنى أقصد شعور اليمنى البسيط السائر فى شوارع صنعاء، إذا مر بمدافن العشرين ألفا من الجنود المصريين الذين دافعوا عن ثورة اليمن وماتوا فى أرضها، وشعور الطفل اليمنى الصغير نحو المدرس المصرى فى قرية فى أعلى جبال اليمن، وشعور المثقف اليمنى نحو العقاد أو طه حسين أو أحمد حسن الزيات، وشعور ربة البيت اليمنية نحو المطربين أو الممثلين المصريين…إلخ.
اكتشفت خلال تلك الزيارة أن جامعة صنعاء تضم ١٣٠ (مائة وثلاثين) أستاذا ومدرسا من بينهم ١١٠ (مائة وعشرة) أستاذ ومدرس مصرى. قال لى أستاذ مصرى من هؤلاء، وكان يدرس القانون فى جامعة صنعاء، أن يمنيا بسيطا استوقف سيارته فى الطريق لمجرد أن يقول له، وهو لا يعرفه، أنه وقف ليشكره لأن مصر هى التى علمت أولاده، ووقفت بجانب اليمن حينما أرادت أن تعرف ما الذى يدور بالعالم. وفى قرية يمنية فى أعلى الجبل، استوقفنى طفل يمنى صغير، عندما عرف ملامحى المصرية، ومد إلى فرخ ورق أبيض يحتوى على امتحان فى اللغة العربية صححه مدرس مصرى. يريد أن يقول لى إنه يعرف الآن القراءة والكتابة.
وفى صنعاء قابلت الإذاعى المصرى الذى ذهب ليدرب المذيعين اليمنيين على إعداد نشرة الأخبار وإخراج التمثيليات، والخبير الإحصائى المصرى الذى يدرب اليمنيين على قيد شهادات الميلاد والوفاة، وعميد الكلية المصرى بجامعة صنعاء الذى يتعلم منه اليمنيون، دون أن يشعر، وهو يظن أنه يقوم بمجرد عمل إدارى، كيف تراعى الأصول فى التعيين أو فى مواعيد الحضور والانصراف. وقابلت المثقف اليمنى الذى دخل علينا متحمسا، وبيده مجلة أسبوعية مصرية، ليقص علينا أدق التفاصيل لآخر أخبار المعركة، الدائرة فى مصر بين أنصار التغيير، وأنصار إبقاء كل شىء على ما هو عليه. فيعلق على ذلك الشاعر اليمنى الجالس على الأرض بقوله: «لله درك يا مصر، ما كل هذه الحيوية التى لا تلبث دائما أن تعود إلى الصحافة المصرية؟». وقد أثر قوله هذا فى نفسى، إذ كنت قد تركت ورائى المثقفين المصريين فى حالة من الإحباط الشديد، ويعتريهم من حين لآخر شعور شديد الوطأة بأنه لا قيمة لأى شىء يكتبونه، وأن الفساد قد استحكم، فمن أين يأتى الأمل؟ ها هو ذا الشاعر اليمى يذكرنا بأن الكلمة الطيبة لا يمكن أن يضيع أثرها، والبذرة التى تلقى فى مصر قد تنبت فى صنعاء، وليس من الضرورى أن يحدث هذا غدا، ولا من المهم أن يعرف من أى بذرة خرج النبات.
قال لى مثقف يمنى آخر يكبرنى فى السن، إنه يتذكر كيف كانت تأتى إلى صنعاء من مصر، فى الأربعينيات من القرن الماضى، نسختان من مجلة «الثقافة»، فكانت النسختان تدوران بين مثقفى صنعاء، ثم ترسلان إلى «تعز» فيتبادلهما مثقفوها، لكى تعودا إلى صنعاء وهما مهلهلتان من كثرة ما تبادلتهما من أياد.
•••
كان الشائع عن المصرى فى ذلك الوقت أنه يذهب إلى دول النفط ليحصل على التليفزيون الملون والمروحة الكهربائية. وكان يؤيد ذلك منظر المدرس المصرى العائد، إذا تصادف أن رأيته فى مطار القاهرة، وهو واقف ينتظر وصول حقيبته وصناديقه الكرتونية، فقد يروعك ما يبدو على وجهه من لهفة، وهو ينتظر بقلق ظهور متاعه الذى رتبه بكل عناية فى الكويت أو الرياض أو صنعاء، وكأنه ينتظر وصول حبيبته أو فلذة كبده. كان منظر هذا المدرس المصرى العائد يلخص مصر كلها: قوتها وضعفها. فانحناء ظهر المدرس المصرى أمام المروحة أو التليفزيون كان يلخص محنة مصر أمام الفقر المفروض عليها ولا تستحقه، وبينما يذهب إلى تلك البلاد أى أوروبى أو أمريكى حاملا حقيبته السامسونايت، تفتح أمامه أبواب الوزراء والكبراء. ولكن تأمل هذا المدرس المصرى نفسه وهو يدرس قواعد اللغة العربية أو مبادئ الحساب فى قرية يمنية نائية، لا يراه أحد غير تلاميذه، ولا يعبأ أحد بمظهره أو بألوان ثيابه. وتأمل المغزى الحقيقى لما يصنعه، تدرك أنه لو أعطى كنوز سليمان لما كفت لمكافأته.
•••
عندما أتذكر كل هذا، وأنا أتابع أخبار اليمن الحالية، أشعر بالحزن لما واجهته النهضة فى اليمن من عوائق خلال الخمسين عاما الماضية، التى تلت ثورة ١٩٦٢، وكأن اليمن عليها أن تبدأ كل شىء من جديد. ولكنى أقول لنفسى أيضا، أن محنة اليمن اليوم ليست مختلفة جدا عن محنة مصر، وقد يعود هذا إلى أوجه شبه مهمة بين البلدين، رغم الاختلاف الشديد بين مسار التاريخ فى كل منهما خلال القرنين الماضيين. فاليمنيون ليسوا من أغنياء النفط. والمنح والقروض تتدفق عليهم كما تتدفق علينا. وقد ورطوا اليمن فى الاستدانة كما ورطونا. ومن أهم مصادر العملات الأجنبية لدى اليمن تحويلات المهاجرين العاملين فى الخارج، كما هو الحال عندنا.
وموظفوهم الحكوميون، كموظفينا، يواجهون نفس الحيرة فى محاولة البحث عن مصدر إضافى للدخل. وثقافتهم تتعرض منذ انفتاحهم المفاجئ على العالم، للأخطار نفسها التى تهدد ثقافتنا. ولكن اليمنيين، كعادة كل العرب فى كل الأوقات…إلخ، يتطلعون إلينا فى صمت، ويتساءلون عما يا ترى مصر فاعلة؟