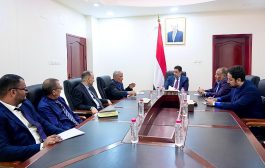فهمي محمد
بين نفوذ سلاح اللجان الشعبية المسيطرة في المناطق الخاضعة للحركة الحوثية، وسلاح المقاومة الشعبية في المناطق المحسوبة على الشرعية، يختفي منطق الدولة التي تتجلى في إحدى مظاهرها الحاكمة كمؤسسة عسكرية عنوانها السياسي الأبرز هو الجيش الوطني.
وهو الجيش الذي يجب أن يخضع بكل تشكيلاته القتالية لوزارة الدفاع، وخضوعه لرئيس الجمهورية في حال أن يكون هذا الأخير بموجب الدستور والقانون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ناهيك عن ضرورة أن تتأسس عقيدة هذا الجيش على قيم ومبادئ وثقافة الولاء للفكرة الوطنية التي تجعل من سلاح الجيش قوة وعقيدة قتالية عسكرية معنية بدرجة رئيسية بحماية سيادة الدولة والسيادة الوطنية، وحتى حماية النظام السياسي الديمقراطي في الدول التي يقر دستورها مسألة التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وبغض النظر عن مشروعية فعل الانقلاب من الزاوية السياسية والقانونية نستطيع القول إن قادة الانقلابات التي جرت وتجري في العالم، كما هو الحال مع آخر الانقلابات الجارية في النيجر، ظلوا متمسكين برمزية الجيش كمؤسسة عسكرية حاضرة تجعل من سلطتهم الانقلابية تبدو وكأنها سلطة الدولة الحاكمة.
بمعنى آخر فعل الانقلاب نجده يذهب دائما إلى إزاحة الحاكم واحتلال سلطته السياسية، مع الحفاظ على كيان الدولة، حتى وإن تم تغيير مسار التوجه السياسي مع صعود الانقلابيين إلى رأس السلطة.
لكن الحديث عن المفارقة الأولى التي نحن بصددها تقول إن ما حدث في انقلاب سبتمبر 2014 في العاصمة صنعاء بدأ فعلاً انقلابياً مختلفاً.
فمع أن الجيش قد انضم بشكل أو بآخر إلى صف الانقلاب، إلا أن الانقلابيين مع ذلك لم يتمسكوا بالمؤسسة العسكرية كأساس لسلطتهم السياسية في صنعاء، بل أسسوا سلطتهم على سلاح اللجان الشعبية التي ابتعلت الجيش كمؤسسة عسكرية.
صحيح أن إعلام الحركة الانقلابية يتحدث دائما عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية، إلا أن مجريات الأحداث في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الحوثية تشهد اختفاء دور مؤسسة الجيش لصالح اللجان الشعبية، وذلك في سبيل تأسيس سلطة الجماعة على حساب سلطة الدولة.
وهذه نتيجة طبيعية لكون الانقلاب الذي حدث في 21 من سبتمبر 2014م، لم يكن في الأساس ضد شخص الرئيس عبدربه منصور أو ضد سلطته السياسية، بقدر ما كان انقلاب ضد مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية، أو أنه انقلاب ضد الفرصة التاريخية التي بدا أن اليمنيين معها قادرون على تحويل بلادهم المتعثر إلى وطن ودولة في المستقبل القريب.
من نافلة القول إن مبرر العمل باللجان الشعبية، وبسلطة المشرفين الذين أصبحوا فوق السلطة العامة، يأتي من وعي الحركة الحوثية بحقيقة أن سلطتها السياسية -كجماعة- لن تتأسس في اليمن إلا مع غياب مشروع الدولة الوطنية، بل في ظل تسييد منطق اللا دولة على حساب منطق الدولة، وذلك يتطابق في الأهداف المرسومة مع سياسة الحركة التي تقدم على ادلجة الوعي المجتمعي في مناطق سيطرتها بقيم ثقافية وجدانية مذهبية تؤسس للهويات الجزئية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
ما يعني في النتيجة أن ملشنة السلاح المسيطر باسم الحركة على حساب مؤسسة الجيش وحتى ملشنة أجهزة السلطة العامة بسلاح المشرفين المؤدلجين نستطيع القول عنه أنه يأتي من باب المأثور القائل “ليس بعد الكفر ذنب”!
فمن ينقلب على مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية ولا يؤمن بالدولة كفكرة سياسية فوق السلطة، لا يلام إذا ما ذهب في واقع حاله مع قوة السلاح ومع الفكرة اللا وطنية إلى تأسيس سلطته السياسية على نقائض الدولة والديمقراطية وحتى على نقائض الهوية الوطنية الجامعة للمكون الإنساني.
إذا كانت الإجابة على سؤال ملشنة السلاح والسلطة في صنعاء ومناطق سيطرتها، نجدها في رغبة الانقلابيين في تأسيس سلطة الجماعة اللا وطنية التي يجب أن تبتلع سلطة الدولة، وهو ما تم ترجمته في قدرة سلاح الحركة الحوثية على ابتلاع سلاح المؤسسة العسكرية، وقدرة المشرفين كأشخاص على ابتلاع سلطة المؤسسات الحكومية، فإن الإجابة على سؤال ملشنة السلاح في المناطق المحسوبة على الشرعية هي الأخرى تبدو أكثر مدعاة للحديث عن خطورة استمرارها بعد مرور تسع سنوات على مواجهة الحركة الحوثية تحت مسمى سلطة الشرعية والجيش الوطني.
صحيح أن الظروف الموضوعية التي رافقت انقلاب الحركة الحوثية استدعت العمل بسلاح المقاومة الشعبية لكن ذلك كان من باب الظروف الاستثنائية التي يجب أن لا تتحول إلى اصل ثابت، خصوصاً بعد أن أقدم الجيش على تسلم مقاليد السلطة وحتى سلاح المؤسسة العسكرية للحركة الانقلابية حتى تحول الانقلاب إلى سيل جارف من صعدة إلى عدن، في ظل ذهول سياسي اجتاح النخب السياسية والعامة.
غير أن هذا الذهول بقدر ما كان يحاول فهم ما جرى ويجري ويتساءل في نفس الوقت عن مستقبل الفرصة التاريخية مع هذا السقوط اللا وطني للمؤسسة العسكرية، بقدر ما كان بوعي أو بدون وعي يضع سؤالا مفتوحا أمام الأجيال القادمة عن حقيقة تكوين العقيدة القتالية للجيش اليمني في ظل سياسة الرؤساء السابقين الذين حكموا سلطة النظام الجمهوري وعلى وجه التحديد في شمال اليمن.
إذا كانت التجربة التاريخية للانقلابات تقول إن الجيش يقف مع نجاح الانقلاب أو يقوم بعملية الانقلاب عندما يكون الانقلابيون قادمين من داخل مؤسسة الجيش، ما يعني أن الجيش أو القادة العسكريين يصبحون هم الحكام الجدد وليس العكس، لكن أن يأتي الانقلابيون من خارج مؤسسة الجيش ومن خارج أجهزة السلطة الحاكمة، ناهيك عن كونهم جماعة تحمل مشروعا يعود بالمجتمع إلى ثقافة ما قبل الدولة وثقافة ما قبل الفكرة الوطنية، ومن ثم يذهب الجيش الذي تأسس في ظل الجمهورية ويسلم لمثل هؤلاء القادمين مقاليد السلطة وسلاح المؤسسة العسكرية، فتلك هي المفارقة الثانية التي تميز خصوصية الانقلاب في اليمن، خصوصاً أن هذه المفارقات كارثية تطرح السؤال المفتوح حول حقيقة مهام ودور المؤسسة العسكرية في اليمن.
لهذا نستطيع القول من واقع المفارقتين بأن انقلاب الحركة الحوثية لم يستدع بذاته العمل بسلاح المقاومة الشعبية التي قاتلت تحت لواء السلطة الشرعية، بل هو السقوط اللا وطني للمؤسسة العسكرية الذي استدعى العمل بسلاح المقاومة الشعبية التي وجدت نفسها -مع أكذوبة الجيش الوطني في أحداث الـ21 من سبتمبر- معنية بدور كان يجب أن تقوم به مؤسسة الجيش وقادتها العسكريون ضد انقلاب/ تاريخي/ سياسي/ اجتماعي/ ثقافي/ استهدف في الأساس مشروع التحول/ السياسي / الوطني الديمقراطي/ المستقبلي/ في اليمن التي لم تتحول بعد إلى دولة ووطن.
إذا ما وضعنا الحديث عن الدور المفصلي للقائد العسكري عدنان الحمادي ورفاق دربه من الضباط الوطنيين في اللواء 35 مدرع بين قوسين، بحكم فكرة المقال الذي نتحدث فيه هنا عن اللجان الشعبية والمقاومة الشعبية، نستطيع القول إن هذه الأخيرة كانت هي البندقية الشجاعة التي أوقفت وكسرت تمدد الحركة الحوثية سيما وقد تولت عبر قادتها الشعبيين مواجهة الحركة الحوثية في عدد من جبهات القتال.
لكن تجربة المقاومة الشعبية تقول إن سلاح المقاومة بمقياس العقل السياسي للدولة الوطنية الديمقراطية تحول إلى حالة شعوبية تحت مسمى معركة التحرير، أو تحت رغبة تشكيلات المقاومة الشعبية التي أصبح هدفها تحرير المحافظات من سيطرة الحركة الحوثية، سيما مع تدخل التحالف وتقديمه المال الكثير والسلاح المحدود للمقاومة الشعبية، بحيث تحول الحصول على المال إلى دافع في حمل السلاح لدى البعض، في حين تحول البعض مع المال والسلاح إلى تجار حروب داخل خنادق الانقلاب والمقاومة.
ربما تجربة المقاومة الشعبية في مشرعة وحدنان هي التي حسمت أمرها خلال شهر وخرجت بشرف الانتصار والتحرير دون أن تكون مثقلة بعار الانتفاع من المال والسلاح وتجارة الحروب على حساب الدماء، وذلك يعود لسببين رئيسيين: الأول، أن قادة المقاومة لم يرتبطوا بخط مباشر أو دعم مباشر من قبل التحالف، لهذا كانت المعركة مغرما وليس مغنما بالنسبة لهم.
والثاني، أن الوعي السياسي المجتمعي والحزبي لعب دورا في دعم معركة المقاومة الشعبية.
الحديث عن تحول سلاح المقاومة الشعبية إلى حالة شعوبية بمقياس فكرة الدولة الوطنية الديمقراطية، يعني أن سلاح المقاومة الشعبية وجد نفسه بيد شيخ الغنيمة وشيخ القبيلة وشيخ الفتوى، في حين وجد جزء آخر من سلاح المقاومة نفسه بيد القادة العسكريين الذين بدأوا يؤسسون ألوية عسكرية تحت مظلة الشرعية.
لكن الملاحظ أن سلاح المقاومة الشعبية الذي نحن بصدده، وإن كان قد قاتل تحت مظلة الشرعية إلا أن دوافعه كانت هي التخلص من سيطرة الحركة الحوثية دون الاكتراث بمسألة القتال في سبيل المشروع السياسي الوطني الذي انقلبت عليه الحركة الحوثية (مخرجات الحوار الوطني الشامل)، اي أن سلاح المقاومة الشعبية الذي نتحدث عنه هنا هو السلاح الذي لم يقاتل سياسياً في سبيل الانتصار لفكرة الدولة الوطنية الديمقراطية في اليمن.
وهذا السلاح المقاوم من جهة أولى بقدر ما كان وما يزال تعنيه مسألة تغيب منطق الدولة الوطنية الديمقراطية في المناطق المحررة، بقدر ما يعنيه من جهة ثانية عدم تحويله سياسياً إلى سلاح مؤسسة عسكرية وجيش نظامي خاضع لوزارة الدفاع، ما يعني في النتيجة النهائية إذا كان الهدف من سيطرة سلاح اللجان الشعبية وسلاح المشرفين هو تأسيس سلطة الجماعة على حساب سلطة الدولة في صنعاء، فإن الحديث عن سلاح المقاومة الشعبية، أو الإبقاء على تشكيلات مسلحة خارجة عن وزارة الدفاع، يعني العمل على تأسيس سلطة الجماعة على حساب فكرة الدولة الوطنية الديمقراطية في اليمن، خصوصاً بعد مرور تسع سنوات كانت كافية لخلق جيش نظامي يعمل على تسييد منطق الدولة الوطنية، ويجسد سلطتها في مناطق الشرعية.
ومع ذلك إذا كان العديد من أفراد الجيش أو الالوية العسكرية النظامية الخاضعة لوزارة الدفاع في حكومة الشرعية، يتصرفون حتى اليوم في مناطق الشرعية بمنطق المليشيات المسلحة التي تصادر منطق الدولة، حيث نجدهم بسلاح مؤسسة الجيش يمارسون جرائم القتل وغيرها، في ظل عجز قيادة الجيش عن احتواء سلاح الأفراد المنفلت تجاه صدور المواطنين.
ألا يعني ذلك أن الحديث عن سلاح المقاومة الشعبية وعن معسكرات غير نظامية، مع هكذا حال يكون هو الآخر من باب “ليس بعد الكفر ذنب”؟